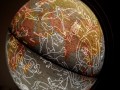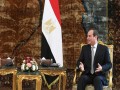الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
حكمة جحا مازالت صالحة إلى اليوم

بقلم - توفيق بو عشرين
تروي الحكاية أن هارون الرشيد إمبراطور الدولة العباسية غضب يوما من جحا زمانه، فعاقبه بطرده ليس فقط، من القصر، حيث كان جزءا من حاشية أمير المؤمنين، بل قرر الأخير طرده من بغداد كلها، فما كان من جحا إلا أن جمع أغراضه وجاء بحمار عليه (شواري) وبدأ يضع أغراضه في جهة دون أخرى من الشواري، فأطلت عليه زوجة الخليفة زبيدة، وقالت له: ماذا تفعل يا جحا؟ قال أحمل أغراضي للرحيل، ألم تسمعي بقرار زوجك أبو جعفر بطردي من القصر والمدينة، قالت بلى، ولكنك جعلت كل أغراضك في جهة دون أخرى فوق ظهر الحمار، وهذا سيفقده التوازن وسيسقط المتاع في الأخير، رفع عينه فيها وقال: يا مولاتي هذا ما قلناه لزوجك فطردنا من القصر ومن المدينة…
التوازن في حياة الفرد كما في حياة الدول هو سر الاستقرار والنجاح، والتطور والعدل ورضا كل واحد بما عنده.. أما عندما يختل الميزان ويضيع التوازن، فإن باب الشرور يُفتح على مصراعيه…
الشعار الثاني للمملكة المغربية بعد التاج الذي يحرسه أسدان، هو الميزان المائل، والتوازن المختل، في كل صغيرة وكبيرة. في الدستور هناك ميزان مختل، وفِي الحياة السياسية هناك ميزان مختل، وفِي الإدارة هناك ميزان مختل، وفِي القضاء هناك ميزان مائل، وفِي الحياة الاقتصادية هناك ميزان أعوج، وفِي الحياة الاجتماعية هناك ميزان راجح لكفة دون أخرى، وفِي منظومة القانون هناك ميزان مختل، وفِي الأسرة هناك ميزان مختل، وكذلك الأمر في المدرسة والجامعة والمعمل والشركة والحكومة والبرلمان، حتى في البيئة هناك موازين مختلة…
هذه الاختلالات في كل تفاصيل حياة المغربي قديمة، أو كما قال السلطان مولاي حفيظ (داء العطب قديم في المغرب)، لكن الجديد فيها أمران: الأول أن هذه الاختلالات تزيد كل يوم ولا تنقص، لأن أسلوب إدارة الدولة ينتج كل يوم عدم التوازن بين السلطة والمواطن، بين القوي والضعيف، بين الغني والفقير، بين البوادي والمدن، بين الأحياء الراقية والحارات الشعبية… أما الأمر الثاني، فهو أن صبر الناس قل، وتطلعات الشباب زادت، والخوف في النفوس يتلاشى يوما بعد آخر من عصا السلطة، وكل هذا يخلق توترات ظاهرة وخفية بين السلطة والمجتمع، وما نراه في الريف اليوم، من (تمرد اجتماعي) أكمل سنته الأولى، سوى دليل على عدم القبول بواقع اللا توازن في الحياة العامة، ومعه نرى فشل الحكم في احتواء هذه الموجة الجديدة من الحراك الاجتماعي، سواء بالإقناع أو بالقمع أو بالمحاكمات أو بالوعود…
عندما تصبح الدولة عاجزة عن حل مشاكل صغيرة أو متوسطة يبدأ المواطنون في وضع يدهم على قلوبهم، وبعضهم في التفكير بالنجاة الفردية من السفينة عندما تبدأ بالغرق، لهذا نرى عشرات الآلاف من المواطنين أغنياء وفقراء، متعلمين وأميين، أصحاب مهن وعاطلين، يفرون خارج البلد، في هجرة قسرية إلى أوروبا أو كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ففي سنة واحدة التحق بألمانيا وحدها أكثر من 20 ألف مغربي سافروا من الدار البيضاء إلى تركيا ومنها إلى اليونان وصولا إلى ألمانيا سيرًا على الأقدام، حيث تسللوا وسط اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان الفارين من جحيم الحرب في بلدانهم… ماذا يعني هذا؟
المغرب لا يعطي أملا للعيش في المستقبل، لا للغني ولا للفقير، لا للصغير ولا للكبير، لا للمتعلم ولا للأقل تعلما… نعم، أوضاع المملكة لا تقارن بسوريا والعراق واليمن والصومال ومالي والجزائر وحتى مصر، لكن المغاربة لا يرون في هذه الدول نموذجا، ولا يقارنون بين أحوالهم وأحوال العرب والأفارقة، بل يتطلعون إلى نماذج قريبة منهم جغرافيا وثقافيا وحضاريا، أي أوروبا بالدرجة الأولى، ثم كندا وأمريكا وبعض الدول الأخرى، وهنا تلعب التكنولوجيا دورا هائلا في تقريب المسافات والقفز فوق الجغرافيا والتاريخ واللغة والثقافة، لتصير الأحلام متقاربة ونمط العيش متقاربا، والآمال متطابقة بين شباب الشمال الغني والديمقراطي والمستقر وشباب الجنوب الفقير والسلطوي، والذي يعيش في فوضى غير خلاقة…
الطبقة الحاكمة اليوم لا تفكر سوى في الحاضر وفِي التاكتيك، وفِي المناورات الصغيرة، وفِي سياسة تغيير كل شيء حتى لا يتغير شيء، ولا تنشغل بالمستقبل لوضع استراتيجية للنهوض بالبلد، وجعله جذابا ليعيش أبناؤه أولا، وليعيش الآخرون ثانيا. كل صاحب سلطة في البلد يسعى إلى أن يحتفظ بأكبر قدر منها بين يديه، والهدف ليس النهوض بالبلد، بل بمنع الآخرين من اقتسام السلطة معه، وكذلك صاحب المال وصاحب الإدارة وصاحب الجاه. والنتيجة هي أن البلد صار غرفة انتظار كبيرة تسع 34 مليون مغربي، بعضهم ينتظر السفر إلى الخارج عبر هجرة قانونية أو غير قانونية، وبعضهم يئس من الدنيا ويستعد للسفر إلى الآخرة، وبعضهم يراكم المال عله يعصمه من الفوضى، وبعضهم ليس له ما يخسره، يراقب الأزمة ويقول: “اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين”.
GMT 14:15 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
في ذكرى النكبة..”إسرائيل تلفظ أنفاسها”!GMT 12:08 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
مشعل الكويت وأملهاGMT 12:02 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
بقاء السوريين في لبنان... ومشروع الفتنةGMT 11:53 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
“النطنطة” بين الموالاة والمعارضة !GMT 11:48 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
نتنياهو و«حماس»... إدامة الصراع وتعميقه؟يونس السكوري يكشف عن جهود الحكومة المغربية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة
الرباط - المغرب اليوم
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، الجمعة بمجلس النواب، عن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. وأبرز السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة و...المزيدالمغربية فاتي جمالي تخوض تجربة فنية جديدة أول خطوة لها في عالم الدراما المصرية
الرباط - المغرب اليوم
دخلت الممثلة المغربية فاتي جمالي تجربة فنية جديدة كأول خطوة لها في عالم الدراما المصرية، من خلال تجسيد شخصية « روني » في المسلسل المصري الجديد « نقطة سوداء الذي اطلق عرض حلقاته عبر قناة « إم بي سي مصر » ...المزيد"غوغل" يحتفل بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة
الرباط - المغرب اليوم
يحتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة، حيث ظهرت واجهته للمستخدمين المغاربة مزينة بعلم المملكة على خلفية تمثل السماء الصافية والسحب.وقد فعل مرك البحث "غووغل" خاصية الن�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©