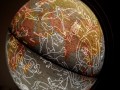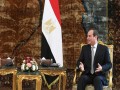الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
رئيس الديوان

رشيد مشقاقة
اندهشت لما رأيت قاضيا متقاعدا بأحد الحمامات الشعبية وهو يستخلص من المستحمين ثمن تذكرة الاستحمام، ويتأكد ما إذا كان مرافقيهم من الأطفال قد بلغوا سن أداء التذكرة أم لا. وتأكد لي أيضا صدق الخبر الذي أبلغني به صاحبي لما رأى قاضيا متقاعدا يسوق شاحنة تحمل الخضر من السوق المركزي.
وجال بي خاطري نحو أرض الكنانة، وأنا أرى بعين الخيال قضاتهم المتقاعدين، وقد راكم البعض منهم تجربة فتفرغ للتأليف ونشر العلم، والبعض منهم جلسوا بناديهم إلى زملائهم القضاة محافظين على هيبة القضاء وسلطانه.
وأيقنت أننا لا نعرف ماذا تعني صفة قاض التي نحملها، وأن هناك مأموريات خدماتية لا تليق بتاتا بالقاضي سواء كان عاملا أو متقاعدا. وقد ضاق أحد القضاة ذرعا بسلوك رئيس ديوان الوزير زمنا، فهو يقدر فيه صفة القاضي التي يحملها، لكنه لما تحول إلى آمر ناه باسم الوزير السياسي صرخ في وجهه قائلا: «اسمع يا هذا، إن ما جرى به العمل أن تتألف دواوين الوزراء من أتباعهم بالحزب الذي ينتمون إليه، وقد يكونون من الموظفين البسطاء أو العاطلين أو الأميين. ويبدو أنك في المكان غير المناسب».
لم يخطئ القاضي الغاضب، فما يسعى إليه بعضنا سعيا يخدش مكانته داخل المجتمع، وقد أجاب الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) القاضي علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) عندما قال له: «أنا أحق بأن آتيك يا عمر». رد عليه عمر قائلا: «القاضي يُؤتى ولا يأتي.»
فلو أمعنا النظر في سر تراجع هيبة القاضي لصارحنا أنفسنا بأننا نحن القضاة الذين نجرها إلى الحضيض.
لازالت قصة ذلك القاضي الطيب، وقد غادرنا إلى دار البقاء حاضرة أمامي، فقد ظل يكظم غيضه من غطرسة مديره إلى أن جاء ذلك اليوم الذي تجرأ فيه عليه وأمره أمام جمع غفير من الحضور أن يأتيه بكأس قهوة من المقصف، فانتفض القاضي الراحل قائلا: «اذهب أنت فأنا لست نادلا. احترم صفة القاضي التي نحملها معا وغادر المكان».
ختم القاضي حياته بهذا الموقف الشجاع، وهو موقف كان ينبغي لزملائه أن يكرروه لنزع فتيل الاستبداد والاستعباد الذي مورس عليهم من طرف كائن متجبر وليس بشرا، ولكنهم آثروا السلامة وفوضوا أمرهم إلى الله.
نحن نستنكر تدخل الغير في مهامنا، وننادي برفعة القضاء وسموه، ولكننا في الوقت ذاته نفُتُّ في عضده، فقد كان للقضاة المتدربين حافلتهم الخاصة، ثم اختلط الحابل بالنابل، وكان لهم ناديهم الخاص ففتح النادي ذراعيه للمنخرطين من كل حدب وصوب. فالتفريط في هذه الجزئيات البسيطة وخدش خصوصية وتحفظ القاضي، تبعه مسلسل حذف السلطة التقديرية في عدة مجالات وإقحام وسائل بديلة لحل المنازعات.
وقد أبدى صاحبي الصحافي أسفه عندما شاهد رجلا أنيقا يضع منديلا على كتفه ويقدم طست الماء للضيوف الأكابر، فلما جلس إلى جواره سأله عن مهنته فقال: «أنا قاض. وخادم القوم سيدهم».
والحق أقول: «لم يظلمنا أولئك الذين يريدون تسليع القاضي وتحويله إلى آلة تقنية صماء. لم يظلمنا أولئك الذين يضعون رجلا فوق رجل ليصلحوا مهنتنا وهو في حكم مساعدي العدالة لا أقل ولا أكثر. لم يظلمنا أولئك الذين يصرون على أن تؤدى يمين القضاة أمام زملائهم لا أمام جلالة الملك الذي تصدر الأحكام باسمه. ولم يظلمنا أولئك الذين نفشي إليهم أسرارنا ونوشي ببعضنا البعض ونؤلب الصدور وننتهز الفرص.
نحن من ظلمنا ونظلم أنفسنا، عندما نجهز على من يقول كلمة الحق، ونسخر انتخاباتنا لخدمة من ينظم الطواف عبر محاكم المملكة ليصبح بين ليلة وضحاها مسؤولا قضائيا بيننا. وهي فئة غالبة لغاية يومه».
أَبعدَ هذا كله، تستنكرون علينا متى طالبنا بتقوية جهاز المناعة ضد أخطاء الأمس وتفاديها في مشروع القانونين التنظيميين للقضاة والسلطة القضائية؟ ومن المضحكات المبكيات أن يعارض القضاة أنفسهم في ذلك، وهم من الفئة التي زمجر في وجهها ذلك القاضي المتقاعد حاليا عندما قال لرئيس الديوان:
«أنت في المكان غير المناسب، فالقضاة ليسوا سُعاة».
يونس السكوري يكشف عن جهود الحكومة المغربية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة
الرباط - المغرب اليوم
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، الجمعة بمجلس النواب، عن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. وأبرز السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة و...المزيدالمغربية فاتي جمالي تخوض تجربة فنية جديدة أول خطوة لها في عالم الدراما المصرية
الرباط - المغرب اليوم
دخلت الممثلة المغربية فاتي جمالي تجربة فنية جديدة كأول خطوة لها في عالم الدراما المصرية، من خلال تجسيد شخصية « روني » في المسلسل المصري الجديد « نقطة سوداء الذي اطلق عرض حلقاته عبر قناة « إم بي سي مصر » ...المزيد"غوغل" يحتفل بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة
الرباط - المغرب اليوم
يحتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة، حيث ظهرت واجهته للمستخدمين المغاربة مزينة بعلم المملكة على خلفية تمثل السماء الصافية والسحب.وقد فعل مرك البحث "غووغل" خاصية الن�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©