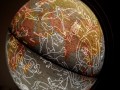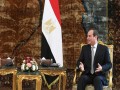الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الديمقراطية وأزمة السلطة

أمير طاهري
بقلم : أمير طاهري
يحلم إدموند دانتيس بالحرية في زنزانته بسجن «شاتو ديف»، وهو بطل رواية ألكسندر دوماس «الكونت دي مونت كريستو» لعام 1844. ويحلم بأن يكون ميناء مرسيليا القريب ملاذاً للسلام والحرية. وبعد قرنين من الزمن، ربما أعاد دانتيس النظر في حلمه بوصف «مرسيليا»، ثاني أكبر مدينة في فرنسا وأكبر موانئها، صارت النسخة الأوروبية من مدينة «شيكاغو» الأميركية في زمن حظر تجارة الخمور مع حروب العصابات المحلية، وإطلاق النار في كل مكان، والإضرابات الاحتجاجية من الشرطة، والتوترات بين مختلف المجتمعات المحلية التي صارت من سمات الحياة اليومية.
تصف وسائل الإعلام الفرنسية المهذبة، وربما المروَّضة، عادةً الوضعَ بأنه «تحدٍّ للقانون والنظام» في حين يتحدث وزير الداخلية الفرنسي، وبالتالي رئيس الشرطة الأعلى جيرارد دارمانان، عن «انتشار السفاهة على نطاق واسع». ويذهب الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ما هو أبعد من ذلك بالتحذير من «فقدان السلطة» الذي يعتزم تصحيحه عبر تدابير غير معروفة حتى الآن.
إن فقدان السلطة لا يقتصر على عصابات مارسيليا التي تخوض حرباً على حصة أكبر من سوق المخدرات مع عصابات آلياردي النيجيرية، و«أخويات» الشمال الأفريقي، وعصابات البلقان التي تُحاول الاستحواذ على أو الدفاع عن وتوسيع نُطُق نفوذها. وتتعرض السلطة أيضاً لتحديات مستمرة في باريس نفسها، إذ يمكن للمرء أن يرى الكثير من نوافذ المتاجر التي حطمها المتظاهرون في أعمال الشغب الأخيرة ضد زيادةِ سنتين على الحد الأدنى القانوني لسن التقاعد. وحتى المدن التي كانت معروفة بالهدوء والسكون مثل «نيم» و«ليموج» تأثرت بـ«فقدان السلطة».
لذلك، ليس من المستغرب أن يختار الرئيس ماكرون «استعادة سلطة الدولة» موضوعاً رئيسياً لأدائه السياسي في فترة ما بعد العطلات. وفي مقابلة صحافية أُجريت معه الأسبوع الماضي ذكر كلمة «السلطة» 15 مرة، ثم دعا الأحزاب السياسية والنقابات المهنية إلى حضور اجتماعات في قصر الإليزيه لبحث سبل استعادة سلطة الدولة المفقودة في الظاهر.
مع ذلك، تبدو أولى خطوات ماكرون والأفكار التي تتداولها حاشيته أقرب إلى الرقص حول القضية بدلاً من معالجة أسبابها الجذرية.
جاءت الخطوة الأولى في شكل فرض حظر على ارتداء الزي الفلكلوري لشمال أفريقيا، المسمّى «العباءة»، في المدارس العامة. يعرض وزير التعليم الجديد غابرييل أتال هذه الخطوة على أنها «إجراء عاجل لحماية القيم العلمانية للأمة الفرنسية».
هذا رغم حقيقة أن المجلس الفرنسي للطوائف الإسلامية -المجموعة المموّلة حكومياً- قد حكم بأن العباءة ليست رمزاً إسلامياً.
من أين تأتي السلطة؟
الإجابة التقليدية أنها تأتي من أداتين رئيسيتين للإقناع والإكراه تمتلكهما حكومة مُشكّلة بالشكل اللائق لفرض قراراتها. ولكن بعيداً عن ذلك، فقد يزعم المرء أن السلطة تنبع من استمرارية القواعد والأعراف، وتراكم التراث الثقافي، بما في ذلك التراث الديني، الذي يتجاوز الاعتبارات الآنيّة.
في ضوء ذلك، يمكن للمرء الزعم أن فرنسا فقدت مفهوم السلطة مع ثورتها الكبرى الأولى في القرن الثامن عشر.
تتناقض الصيغة الثلاثية لتلك الثورة، وهي الحرية والإخاء والمساواة، مع مفهوم السلطة الذي يستلزم وجود تسلسل تراتبي للمكانة الاجتماعية وبالتالي السياسية. إن «الحرية»، التي لا تُعرّف ضمن الحدود القانونية، من الممكن أن تشجع النزعة الفردية المفرطة، إن لم تكن الفوضى. ومن شأن «الإخاء» أن يُحدث تمييزاً اجتماعياً وثقافياً ودينياً، ثم المسؤوليات في خدمة الدولة في نهاية المطاف، في حين أن «المساواة» تمثل تحدياً للسلطة التي بُنيت على التسلسل التراتبي.
يحاول الرئيس ماكرون معالجة هذه المشكلة بالحديث عن «الواجبات» بدلاً من «الحقوق»، وهو أمر يتناقض مع القيم الأساسية للثورة الفرنسية. في وجهة النظر العالمية للثورة الفرنسية، يتمتع المواطنون، بغضّ النظر عمّا إذا كانوا يؤدون واجباتهم أم لا، بحقوق غير قابلة للتصرف. في إعادة تعريف ماكرون، قد تبدو حقوق المواطن كأنها مكافآت على المهام التي يؤدونها. لكن مَن يحدد هذه الحقوق والواجبات؟
الإجابة المقدمة هي العبارة المبتذلة من الديمقراطية التي، في شكلها المجرد، يمكن أن تعني استبداد الأغلبية. وبمعنى آخر، أسوأ أنواع الاستبداد.
هل يمكن للمرء الحديث عن واجبات في خدمة نظام استبدادي لم يختره؟ وتزداد الأمور سوءاً حين تتشكل حكومة من دون أغلبية، كما هي الحال في فرنسا، وفي أشكال مختلفة في الكثير من الديمقراطيات الغربية اليوم. قد يؤدي ذلك إلى موقف غريب، حيث قد تكون شاغلاً للمنصب ولكنك لست في السلطة، أو حتى إذا تمكنت من محاكاة كونك في السلطة، فأنت لست في السلطة على الحقيقة. وفي الحالة الأخيرة، قد يأتي الإكراه بديلاً عن السلطة، ومن ثم ينشأ استخدام الشرطة للعنف على نطاق واسع وبصورة متزايدة «لاستعادة القانون والنظام».
كما أن الاستقامة السياسية وتمجيد الضحايا يزيدان المسألة تعقيداً.
إذا تحدثت عن السلطة، كما تفعل الحكومات الحالية في المجر وبولندا، فسوف يطلَق عليك وصف «السلطوي» إن لم يكن «الاستبدادي». وكل مَن يدّعي وقوع ضحية، تاريخياً، أو عرقياً، أو دينياً، أو ثقافياً، أو جنسياً، أو طبقياً، يستطيع أن يطالب بإعفائه من احترام أي سلطة خارج دائرته الخاصة.
في المعجم الصحيح سياسياً لا يتحدث المرء عن إطاعة القانون بل عن احترامه عندما يرى المرء أن القانون جدير بالاحترام. كما يستخدم ناشرو مبدأ الاستقامة السياسية اصطلاح «الموافقة» بديلاً للطاعة في نظام قائم على القانون. وعليه، فإن الموافقة المصطنعة تتحول مع الوقت إلى مشروع تجاري، وهي في الولايات المتحدة على الأقل، تتطور إلى فن إن لم يكن علماً كاملاً.
إن أداة ماكرون لتصنيع الموافقة المصطنعة هي إجراء استفتاءات حول «القضايا الرئيسية المؤثرة على حياة المواطنين». ويعتزم تعديل الدستور للسماح للحكومات بتنظيم استفتاءات حول منظومة أوسع من القضايا. وهذه بطبيعة الحال وسيلة لتقليص سلطة الديمقراطية التمثيلية، وعلامة على الكسل السياسي. لا يمكن حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بـ«نعم» أو «لا» من الجمهور الذي يفتقر إلى المعلومات الضرورية ومهارات التحقيق حتى وإن توجهت أغلبية الذين يحق لهم التصويت إلى صناديق الاقتراع، على عكس جميع الاستفتاءات التي أُجريت في فرنسا حتى الآن.
استشهد الفيلسوف كانط بثلاثة مصادر للسلطة: السلطة والثروة والاحترام. لكنّ ذلك حدث عندما كان لأوروبا نظام سلطوي، كانت فيه الملكية والأرستقراطية الثرية والكنيسة تمثل فيما بينها سلطوية كانط الثلاثية.
كل نظام يفسد حين نبالغ في تضخيم قيمته الأساسية، وهو ما يعني في هذا السياق أن الإفراط في الديمقراطية يؤدي إلى فساد النظام الديمقراطي الذي تتحرك فيه السلطة متأرجحة كالبندول، إما نحو الاستبداد وإما نحو الحكم.
في معظم الديمقراطيات الغربية اليوم، يقترب البندول بشكل خطير من عدم القدرة على الحكم، وغالباً في شكل حكومات تتظاهر بالحكم على أساس يومي. والتحدي الذي يواجه ماكرون وآخرين هو دفع البندول في الاتجاه المعاكس. ولكن لا تحبسوا أنفاسكم، أو تنتظروا الكثير!
GMT 17:39 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
أي تاريخ سوف يكتب؟GMT 17:36 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
لا تَدَعوا «محور الممانعة» ينجح في منع السلام!GMT 17:32 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
عودة ترمبية... من الباب الكبيرGMT 17:27 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
ترمب الثانيGMT 21:28 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
«هي لأ مش هي»!يونس السكوري يكشف عن جهود الحكومة المغربية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة
الرباط - المغرب اليوم
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، الجمعة بمجلس النواب، عن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. وأبرز السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة و...المزيدالمغربية فاتي جمالي تخوض تجربة فنية جديدة أول خطوة لها في عالم الدراما المصرية
الرباط - المغرب اليوم
دخلت الممثلة المغربية فاتي جمالي تجربة فنية جديدة كأول خطوة لها في عالم الدراما المصرية، من خلال تجسيد شخصية « روني » في المسلسل المصري الجديد « نقطة سوداء الذي اطلق عرض حلقاته عبر قناة « إم بي سي مصر » ...المزيد"غوغل" يحتفل بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة
الرباط - المغرب اليوم
يحتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة، حيث ظهرت واجهته للمستخدمين المغاربة مزينة بعلم المملكة على خلفية تمثل السماء الصافية والسحب.وقد فعل مرك البحث "غووغل" خاصية الن�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©