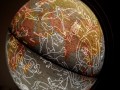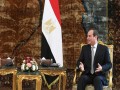الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
في ما خصّ «بيت الخمينيّ»

حازم صاغية
بقلم - حازم صاغية
حين أوردت المصادر الإعلاميّة خبر إحراق بيت الخمينيّ، في مدينة خمين، وسط البلاد، لم يكن المعنى السياسيّ للحدث أوّل ما يتبادر إلى الذهن، أو أنّ ذاك المعنى آثر أن يسلك نحونا طريقاً ملتوية. فالحدث الذي فاق إحراق البيت جذباً للانتباه كان الضمنيّ والمخبّأ، أي وجود البيت نفسه.
هكذا اكتشفنا أنّ آية الله الخمينيّ عاش في بيت، هو «بيت الأجداد» كما قالت الصحف، وبين غرف ذاك البيت سبق لأسرة ولأهل أن أقاموا وعملوا على رعاية نجلهم الصغير وعلى تربيته.
مصدر الاستغراب أنّ الصورة التي رسمها النظام الإيرانيّ منذ قيامه في 1979 تقول إنّ ما يسري على البشر العاديّين، الذين يولدون في بيوت ويقيمون بين أهل ويربّيهم آباء وأجداد، لا تسري على الخمينيّ. فالأخير، الذي قُدّس ونُزع عنه ما هو إنسانيّ، كما أُسبغ عليه الخارق وغير المألوف، بات من الصعب تصوّره سليلَ بيت وأجداد. إنّه، على العكس، يأتي من قدر أو يهبط على الأرض من غموض مُعجز.
يعزّز الاندهاش هذا أنّ البيت والعائلة التي تحيط بالنشأة الأولى، ليسا فقط من أكثر العناصر حميميّة في سيرة شخص ما. إنّهما، فوق ذلك، صاحِبا إسهام كبير في صنع الشخص المعنيّ، أيّ شخص كان. أمّا الصورة الرسميّة التي رُسمت للخمينيّ فتحرّره من أن يكون مصنوعاً صناعةً إنسانيّة، مثلنا جميعاً، كما تنزّهه عن طفولة يصعب افتراض مروره فيها أو عبوره أطوارها. فهو، بموجب إيحاءات الصورة تلك، لم يكن طفلاً ولم ينمُ أو يعرف المراحل والتحوّلات، ولا ربّاه مُربّون أو علّمه معلّمون. إنّه ولد مكتملاً دفعة واحدة، صانعاً لا مصنوعاً.
هكذا يجيء إحراق البيت إحراقاً للأسطورة أيضاً، أو بالأحرى للخرافة التي أحيط بها آية الله العظمى وقائد ثورة 1979. فالجموع الغاضبة في خمين حين أقدمت على ذاك الفعل كانت تمارس عملاً مزدوجاً: من جهة، تؤنسن الخمينيّ بأن تُسكِنه في بيت وتعرّضه لتربية عائليّة، ومن جهة أخرى، تصدر حكمها على الإنسان الذي كانه الخميني، وهو حكم بالغ القسوة والجذريّة:
فإحراق البيت، لا سيّما وأنّه «بيت الأجداد»، أكثر كثيراً من تمزيق صورة أو تحطيم تمثال، لأنّ الصورة علّقها أتباع، تماماً كما أنّ التمثال بناه أتباع آخرون، وهناك دائماً صور كثيرة وتماثيل كثيرة. والشيء نفسه يصحّ في الحجاب المفروض الذي هو، في آخر المطاف، إجراء سلطويّ. أمّا إحراق البيت، وما من بيت سواه، فهو موقف من أصول الأشياء وجذورها، وممّا هو حميم جدّاً وشخصيّ جدّاً في الحياة الفعليّة للخمينيّ وليس في حياته المؤسطَرة. فهنا، في هذا العمل، ثمّة تبرّؤ شعبيّ من كلّ ما يمتّ إليه بصلة أصلاً وفصلاً، صناعةً وإنتاجاً وسلوكاً.
والحرق بالنار ربّما كان أعلى درجات الاستئصال والتطهّر التي تكون مدعاة للاستنكار حين تطال شخصاً عاديّاً مختلفاً عن سواه، أرادت الجموع أن تجعله كبش محرقة لها. أمّا حين تطال شخصاً كالخميني، حكم الملايين بقبضة من حديد قبل أن يورّث البلد لمقلّديه، فتغدو غضباً عادلاً وطلباً على الحرّيّة، تماماً كإحراق سجن أو موقع آخر معروف بظلمه واستبداده.
وحين يقال أنّ هذا البيت جُعل متحفاً «يزوره مؤيّدو النظام»، فهذا إنّما يضعنا أمام معنى آخر وإضافيّ لفعل الإحراق. فالجموع الغاضبة تعلن أيضاً رفضها تخليد الخمينيّ، وجعل بيته مزاراً، وربّما قادتْها المشاعر الجريحة إلى مواقف أشدّ تطرّفاً حيال تحويل الخمينيّة وتراثها إلى تاريخ محفوظ.
بلغة أخرى، تخطو أنسنة الخميني، من خلال الحرق، خطوات ثلاثاً متلاحقة: تعيده طفلاً وتُسكنه بيتاً دلالةً على كونه واحداً من البشر، وتحرق البيت عقاباً له على سيرة وأعمال وسلوك، ثمّ تمنع تحويل البيت متحفاً، أي إعادة أسطَرته ميّتاً بعدما أُسطر وهي حيّ.
يقوّي توقّعاً كهذا عاملان اثنان: أوّلهما أنّه فيما كانت النار تهاجم المنزل، أضرم متظاهرون ناراً أخرى في جزء من مدرسة قم الدينيّة الشهيرة – منصّة انطلاق الخمينيّ الأصليّة والمصدر الأبرز لإنتاج كوادر النظام، كما لإسباغ الشرعيّة الدينيّة المتواصلة عليه. أمّا الثاني فأنّ الشبّان والشابّات هم عصب الثورة الإيرانيّة الراهنة، وهؤلاء، تعريفاً، أكثر الإيرانيّين برَماً وضيقاً بوطأة الماضي الميّت ورموزه على شبابهم ومستقبلهم.
لقد جاء إحراق البيت ليشكّل أعلى درجات كسر الهالة المقدّسة، والهالة والحرّيّة ضدّان لا يلتقيان. بعد هذا الكسر سوف يجهد نظام كالنظام الإيرانيّ، قام إلى حدّ بعيد على واحديّة الهالة وعلى تعاليها، كي يتدبّر أمره مع مستقبل غامض يمسك بأصابعه عيدان كبريت كثيرة.
GMT 17:39 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
أي تاريخ سوف يكتب؟GMT 17:36 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
لا تَدَعوا «محور الممانعة» ينجح في منع السلام!GMT 17:32 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
عودة ترمبية... من الباب الكبيرGMT 17:27 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
ترمب الثانيGMT 21:28 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
«هي لأ مش هي»!يونس السكوري يكشف عن جهود الحكومة المغربية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة
الرباط - المغرب اليوم
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، الجمعة بمجلس النواب، عن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. وأبرز السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة و...المزيدالمغربية فاتي جمالي تخوض تجربة فنية جديدة أول خطوة لها في عالم الدراما المصرية
الرباط - المغرب اليوم
دخلت الممثلة المغربية فاتي جمالي تجربة فنية جديدة كأول خطوة لها في عالم الدراما المصرية، من خلال تجسيد شخصية « روني » في المسلسل المصري الجديد « نقطة سوداء الذي اطلق عرض حلقاته عبر قناة « إم بي سي مصر » ...المزيد"غوغل" يحتفل بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة
الرباط - المغرب اليوم
يحتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة، حيث ظهرت واجهته للمستخدمين المغاربة مزينة بعلم المملكة على خلفية تمثل السماء الصافية والسحب.وقد فعل مرك البحث "غووغل" خاصية الن�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©