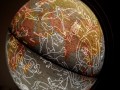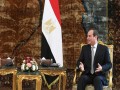الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
هل عاد السودان من حافة الهاوية؟

عثمان ميرغني
عثمان ميرغني
إذا كان الوضع في السودان قبل انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في حالة انسداد شديد جعل الكثيرين يتخوفون من خطر انزلاق البلد إلى مسار العنف والحرب، فإنه الآن أكثر تشرذما وتوترا مع استمرار ارتفاع درجة الاحتقان في الساحة السياسية. فالاتفاق السياسي الموقع بداية هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان الذي أمل البعض أن يؤدي إلى انفراج، واجه معارضة قوية من قطاعات سياسية ومن لجان المقاومة الشعبية التي تقود المظاهرات، ورفع حالة الاستقطاب، وبالتالي ازداد الوضع تعقيدا.
ربما من هذا المنطلق فإن بيانات الترحيب الدولية والإقليمية بالاتفاق السياسي كانت مقرونة بشيء من الحذر وعدته خطوة في طريق إعادة المسار الانتقالي الذي قطعه الانقلاب، ما يعني أن هناك المزيد المطلوب حتى يعتدل المسار ويطمئن الجميع أن السودان يسير في الطريق الصحيح نحو إكمال الطريق والوصول إلى نقطة الانتخابات الديمقراطية. الإدارة الأميركية التي تحركت بقوة ضد الانقلاب، ونسقت التحركات الدولية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس والعشرين من أكتوبر، قالت إنها ستراقب الوضع وتنتظر المزيد من الخطوات والتقدم. ولممارسة المزيد من الضغوط لدفع المسار الانتقالي إلى الأمام أعلنت مع شركائها الغربيين لاسيما الاتحاد الأوروبي أن استئناف المساعدات المالية للسودان مرتبط بالإجراءات التي ستتخذ خلال الأيام والأسابيع المقبلة لضمان استكمال الفترة الانتقالية، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي أدت لمقتل 41 منهم منذ الانقلاب لمحاسبة المسؤولين.
لماذا القلق والحذر؟
على الرغم من أن هذه الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة تدعم استمرار صيغة الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، فإن هناك مخاوف من أن يكون الاتفاق مجرد حركة للمناورة لتخفيف الضغط الخارجي، وأن المكون العسكري والأطراف المتحالفة معه ربما يعملون على عرقلة المسار الانتقالي لاحقا.
فقبل توقيع الاتفاق السياسي بين الفريق البرهان وحمدوك كان الضغط الأميركي خاصة على أشده وبدأ الكونغرس يتحرك لإضافة تعديل على قانون دعم الانتقال الديمقراطي في السودان يفرض عقوبات منتقاة ضد قيادات عسكرية وقوات الدعم السريع وبعض مؤسساتها. هذا الضغط في رأي الكثيرين كان وراء الإسراع بتوقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم الذي أمل المكون العسكري أن يوقف تبني الكونغرس لقراره، لكن الواضح أن موقف واشنطن في أنها ستراقب الأوضاع والتطورات يعني أنها تريد أن تحتفظ بكل أوراق الضغط في يديها.
هناك أيضا مخاوف من أن يؤدي الاحتقان الشديد الحاصل، إلى انفلات الأمور وانفجار الوضع. فالخطورة أنه لأول مرة في تاريخ السودان تدخل الميليشيات في معادلة الانقلابات ويوجد سلاحها في قلب الخرطوم.
وتأكيدا لهذه الحسابات المعقدة والمقلقة حذر مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الذي كان قد عين قبل أشهر حاكما لإقليم دارفور، في مقابلة تلفزيونية قبل يومين من أنه «إذا انفضت شراكتنا فسوف تكون حربا شاملة»، وذلك في إشارة إلى ما تراه الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام على أنه استحقاقاتها في «شراكة وقسمة السلطة»، علما بأن هذه الحركات أو جلها دعمت انقلاب 25 أكتوبر، وشاركت فيه وفي دعمه، كما شاركت أيضا في التحركات التي أفضت إلى الاتفاق الموقع بين حمدوك والفريق البرهان.
سلاح هذه الحركات والدعم السريع يشكل تحديا كبيرا كبيرا في الفترة المقبلة، وسيعتمد الكثير في هذا الملف على الطريقة التي ستدار بها بقية الفترة الانتقالية، وما إذا كان سيحدث التفاف ولو متأخرا حول خطوة حمدوك، أم تستمر المظاهرات والمواجهات الدموية لإسقاط المكون العسكري.
كثير من الأطراف في الداخل والخارج ترى أنه من الصعب إقصاء المكون العسكري بالنظر الى كل التعقيدات الماثلة، لأن ذلك يعني سكب كثير من الدماء؛ لذلك دعت إلى استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري على أساس الوثيقة الدستورية على أمل الوصول بها إلى نهاية الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات الديمقراطية.
والرأي الغالب أنه في ظل الوضع القائم ووجود الميليشيات كرقم جديد في المعادلة السياسية ودورها في الانقلاب الأخير، فإن المظاهرات وحدها لن تسقط النظام إلا إذا انحاز لها الجيش، وحتى في هذه هناك مخاطرة من انقسامات بين العسكريين ووقوع مواجهات دامية بين الجيش والميليشيات.
هناك شرخ في كل الأحوال في الوقت الراهن بين الجيش وقوى الثورة بسبب الهجوم الذي شنه البعض على الجيش، وبغض النظر عن أي حسابات آنية فإن رأب هذا الشرخ ضروري ومهم من أجل مستقبل السودان الجالس في محيط مضطرب ومحاط بكثير من المصالح المتضاربة. هذه المعالجة ستفتح الباب لطرق قضايا إعادة هيكلة القوات المسلحة، وتوحيد البندقية بحيث لا يبقى هناك سلاح إلا في يد القوات النظامية، بعد استيعاب من يتم استيعابه من الحركات المسلحة، ويسرح الباقون.
حساسية الوضع الراهن ربما تفسر الانقسامات في الرأي إزاء توقيع حمدوك للاتفاق السياسي في وقت كان الشارع مستمرا في المظاهرات ضد الانقلاب. فحتى من بين المؤيدين للثورة ارتفعت كثير من الأصوات التي ترى أن حمدوك تصرف بحكمة لوقف نزف دماء، وحتى لا يفقد السودان كل ما تحقق خلال العامين الماضيين على صعيد الانفتاح الدولي وما نجم عنه من المساعدات الاقتصادية وإعفاء الديون، والأهم من ذلك لدرء مخاوف انزلاق السودان نحو عنف قد يجر إلى حرب لا يريدها عاقل. بالطبع مقابل هؤلاء هناك انتقادات واسعة أيضا وقوية للاتفاق السياسي ولحمدوك على أساس أنه عوق الثورة، وإسقاط المكون العسكري وحلفائه من الميليشيات ومن الحركة الإسلامية وفلول نظام البشير الذين يعملون للعودة من بوابة شعار توسيع قاعدة المشاركة السياسية في المرحلة الانتقالية.
الحقيقة أن هناك قوى سياسية من مكونات «الحرية والتغيير» شاركت في الوساطات والمفاوضات التي قادت إلى الاتفاق السياسي. حمدوك تحدث عن ذلك من دون أن يفصح عن أسماء لكن مني أركو مناوى، كشف عن بعض هذه الأسماء، وهناك أمور أخرى سوف تتكشف لاحقا، لكي توضح أن رئيس الوزراء لم يكن وحده وراء الاتفاق وإن كان في الواجهة.
بدلا من تركيز كل السهام نحو حمدوك، فإن الجدير بقوى الحرية والتغيير أن تلم صفوفها وتلتئم لمناقشة كيفية معالجة أخطر وضع يمر به السودان. فليس سرا أن الخلافات في صفوف المكون المدني مهدت للانقلاب الذي حدث، واستمرار هذه الخلافات سيدفع البلد نحو مستقبل مجهول محفوف بالمخاطر. وبغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق مع «الاتفاق السياسي» فإن الحل ليس في المزايدات، بل في التوافق على خريطة طريق تصل بالبلد إلى محطة الديمقراطية وتمنع الانزلاق إلى هوة العنف... أو حتى الاحتراب. فالبلد ما يزال على حافة هاوية.
GMT 17:39 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
أي تاريخ سوف يكتب؟GMT 17:36 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
لا تَدَعوا «محور الممانعة» ينجح في منع السلام!GMT 17:32 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
عودة ترمبية... من الباب الكبيرGMT 17:27 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
ترمب الثانيGMT 21:28 2024 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر
«هي لأ مش هي»!يونس السكوري يكشف عن جهود الحكومة المغربية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة
الرباط - المغرب اليوم
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، الجمعة بمجلس النواب، عن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. وأبرز السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة و...المزيدالمغربية فاتي جمالي تخوض تجربة فنية جديدة أول خطوة لها في عالم الدراما المصرية
الرباط - المغرب اليوم
دخلت الممثلة المغربية فاتي جمالي تجربة فنية جديدة كأول خطوة لها في عالم الدراما المصرية، من خلال تجسيد شخصية « روني » في المسلسل المصري الجديد « نقطة سوداء الذي اطلق عرض حلقاته عبر قناة « إم بي سي مصر » ...المزيد"غوغل" يحتفل بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة
الرباط - المغرب اليوم
يحتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة، حيث ظهرت واجهته للمستخدمين المغاربة مزينة بعلم المملكة على خلفية تمثل السماء الصافية والسحب.وقد فعل مرك البحث "غووغل" خاصية الن�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©